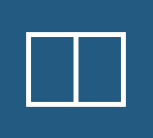إسماعيل بن أبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك ابن أبي عامـر الأصبحي
إسماعيلُ بنُ أبي أُويسٍ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أُوَيسِ بنِ مالكِ ابنِ أبي عامـرٍ الأَصْبحِيُّ
ترجم له الإمام ابن ناصر الدين في كتابه إتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك والذي صدر عن دار المقتبس في طبعته الأولى سنة 1439هـ - 2018م بتحقيق الدكتور إبراهيم حمود إبراهيم،
فقال :
[اسمُه: ] إسماعيلُ بنُ أبي أُويسٍ ([1])عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أُوَيسِ بنِ مالكِ ابنِ أبي عامـرٍ الأَصْبحِيُّ، المدنيُّ، ابنُ عمِّ الإمام مالكٍ، وابنُ أختِه، وصهرهُ على ابنتهِ.
روى عن: أبيه، وخَالهِ مالكٍ([2])، وأخيه أبي بكرٍ عبدِ الحميدِ، وسَلَمةَ بنِ وَرْدَانَ، وسليمانَ بنِ بلالٍ، ونَافعِ بنِ أَبِي نُعَيْمٍ القَارِئِ([3])، وكان خاتمةَ أصحابِه بالمدينةِ.
حدَّث عنه: الشَّيْخَانِ في «الصَّحِيحَينِ» مُحتَجَّين بهِ([4]).
وروى مسلمٌ أيضاً، وأبو داود، والتّرمذيُّ، وابنُ ماجه عن رجلٍ عنه([5]).
وروى عنـه: قتيبةُ بـنُ سعيدٍ، ومحمدُ بنُ يحيى الذُّهليُّ، وأحمدُ بنُ صالحٍ، وآخرُونَ([6]). قال أحمدُ بنُ حنبلٍ: لا بأس بهِ([7]).
وقال يحيى بنُ معينٍ: صَدوقٌ، ضعيفُ العقْلِ، ليسَ بذاكَ([8]).
وذكرَ نحوهُ أبُو حاتمٍ الرّازِيُّ([9]).
وقالَ أبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ: صالحٌ، صدوقٌ، يُدَلِّسُ.
وقال أبُو داود: هو ثقةٌ حافظٌ لحديثِ بلدهِ([10]).
162 ـ وقـد روَى عنهُ إسماعيلُ القاضي حكايةً عَجِيبةً: قال أبُو بكرٍ محمدُ ابنُ الحسنِ([11]) الآجُرِّيُّ([12]) في «فوائدِهِ»([13]): حدثنا أبو بَكرِ بنُ أبي الطَّيِّبِ الهَرويُّ، سمعتُ إسماعيلَ بنَ إسحاقَ القاضي يقول:
سمعتُ ابنَ أبي أُوَيْسٍالمدنيّ يقـول: وَجَّهَنِي أبي يوماً في حاجةٍ فقلت: أبْدأُ بالروضـةِ، فأصلِّي فيهـا ركعتين، ثم أمْضِي في الحاجةِ، فجئتُ الرّوضةَ، فإذا بنَفرٍ منَ الأَشْرافِ جلوسٌ عندَ القبرِ، فجاءَهُم شيخٌ، فقامُـوا إليـه وعظّموه، فقال: ما يُجْلسكُم هاهُنـا؟ فقالُوا: كُنّا اليوم في جماعةٍ منَ البكرِيِّين في موضعِ /[37 ـ أ] كذا وكذا، فجرَى بيننا وبينهُم خطبٌ، فاحتجُّوا علينا بأشياءَ. قال: فقال: فإِيْشْ الحِيْلَةُ إن كانت صلاةٌ.
قال أبُو بكرٍ: وإن كانت مشورةٌ.
قال أبُو بكرٍ: وإن كانت هجرةٌ.
قال أبُو بكرٍ: ما بليّتكُم غيرُ صاحبِ هذا القبرِ.
قال: ومدَّ يدهُ إلى القبر، فذهب يردُّها، فجفَّت، فحملُوه جافَّ اليدِ.
[وفاته: ] توفِّي إسماعيلُ بنُ أبي أُويسٍ سنةَ ستٍّ([14])، وقيل: في شهرِ رجبٍ، سنةَ سبعٍ وعشرينَ ومائتينِ([15]).
163 ـ أخبرنا أبُو هريرةَ عبدُ الرحمنِ بنُ الذَّهَبِيِّ، أخبرنا القاسمُ بنُ المُظَفَّرِ سماعاً، ومحمدُ بـنُ محمـدِ بنِ أبي نصـرٍ قراءةً عليه وأنا حاضرٌ قالا: أنبأنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ عبدِ الواحدِ المَدِينيُّ، أخبرنا إسماعيلُ بنُ عليِّ النَّيسابوريُّ قراءةً عليه وأناأسمعُ، أخبرنا أبُو مسلمٍ محمدُ بنُ عليٍّ المُفَسِّرُ، أخبرنا أبُو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ المُقـرِئِ، حدثنـا مأمُونُ بـنُ هـارُونَ، حدثنا الحسينُ ـ يعني: ابنَ عيسى ـ الطَّائِيُّ البِسْطَامِيُّ:
حدثناإسماعيلُ بنُ أبي أُويسٍ، حدثني مالكُ بنُ أنسٍ، عن أبي بكرِ بنِ نافعٍ، عن أبيه، عن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمرَ بِإحْفَاءِ الشَّوَاربِ([16])، وإِعْفاءِ اللِّحَى([17]).
تابعهُ القَعْنَبيُّ([18])، ويحيى بنُ يحيى اللَّيْثيُّ([19])، عن مالكٍ([20]).
وشيخُه أبُو بكرٍ([21]) هو: ابنُ شيخِه نافعِ بنِ سَرْجِسَ الدَّيْلَمِيُّ مولى ابن عمرَ.
قال يحيى بنُ مَعِينٍ: كانوا إخوةً ثلاثةً: أبو بكرٍ، وعمرُ، وعبدُ اللهِ([22]).
قال: وأبو بكرٍ بنُ نافِعٍ مولى ابنِ عمرَ ليس بهِ بأسٌ([23]).
وقال الإمامُ أحمدُ: هو أوْثَقُ الإخوةِ([24]).
قلت: وعبدُ اللهِ ضَعَّفُوهُ([25])، وعمرُ خُرِّج له في «الصحيحينِ» وغيرهِمَا منَ «السُّننِ»([26]).
164 ـ وقـال أبُـو الحسنِ عليُّ بنُ عمرَ الدَّارَقُطْنِيُّ في «أَخبارِ مـنْ حَدَّثَ وَنَسِـيَ»([27]): حدثنا محمـدُ بنُ مَخْلَدٍ، حدثنا حمادُ بنُ المُؤَمَّلِ بنِ مَطَرٍ الكَلْبِيُّ، حدّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ أبُو بكرٍ النَّاقِدُ:
حدّثنا إسماعيلُ بنُ أبي أُويسٍ، حدّثني خالي مالكُ بنُ أنسٍ عنِّي، عن كَثِيرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ عَوْفٍ، عن أبيِـه، عن جدِّه رضي الله عنه قال: قال عمرُ بنُ الخطّابِ رضي الله عنه/[37 ـ ب ]: ابنُ السَّبيلِ أَحقُّ بالماءِ والظِّلِ منَ التَّانِىء عليهِ([28]). قال أبُو بكرٍ: فقلتُ لإسماعيلَ: حدّثنا أنت، فقال: حدّثني كَثِيرُ بنُ عبدِ اللهِ، ولكنِّي أُحبُّ أُدخلُ اسمَ خالِي فيهِ ([29]).
رواهُ زيدُ بنُ الحُبَابِ عن كَثِيرٍ بنحوِهِ. و«التَّانِئُ»: المُقيمُ المسْتَوطنُ من قولهِم: تنأْتُ بالبلدِ تُنُوْءاً، إذا أوطنتُهُ([30]).
ومنهُم مَن لم يَهْمِزْهُ، يقولُون: تَنا بالمكان يتنُو فهو تَانٍ، والجمع تُنّاءٌ، إذا أقامَ بهِ([31]).
165 ـ و أنبأنَا الحافظُ أبُو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ، أخبرنا أبُو الفتحِ محمدُ بنُ عبدِ الرَّحيمِ سماعاً، أخبرنا عبدُ الوهابِ بنُ ظَافِرٍ، أخبرنا أبُو طاهرٍ أحمدُ بنُ محمدٍ الحَافِظُ، أخبرنا المباركُ بنُ عبدِ الجبَّارِ، أخبرنا عليُّ ابنُ أحمدَ الغَالِي، أخبرنا أحمدُ بنُإسحاقَ النَّهَاوَنْدِيُّ، أخبرنا الحسنُ بنُ عبدِ الرحمنِ القاضي، حدثنا الحسنُ بنُ سَهلِ ابنِ سعيدٍ العَسْكَرِيُّ، حدثنا نصرُ بنُ داودَ بنِ طَوْقٍ:
حدثنا ابنُ أبي أُويسٍ، سمعتُ مالـكَ بنَ أنسٍ يقول: «إنَّ هذا العلمَ هُو لَحمُكَ ودمُكَ، وعنْهُ تُسأَلُ يومَ القيامةِ، فانْظُرْ عمَّنْ تأْخذُهُ»([32]).
166 ـ وجـاءَ هـذا المعْنى مرفُوعاً فيمَا رواهُ أبُو نُعَيْمٍ أَحمَـدُ بـنُ عبـدِ اللهِ الأَصْبَهانيُّ: حدثنا عليُّ بنُ هارونَ،
حدثنا الحسنُ بنُ الفَتـحِ الشَّاشِيُّ، حدثنا حبيبُ بنُ مُغـيرةَ الشَّاشِيُّ، حدثنا المباركُ([33]):
حدثنا عَطَّافُ بنُ خَالدٍ، عن نَافعٍ، عن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قـال له: «يا ابنَ عُمرَ! دِينَكَ دِينَكَ، إنَّمَا هوَ لَـحْمُكَ ودَمُكَ، فانْظُرْ عمَّن تَأخُذُ دينكَ، خُذْ عن الَّذينَ اسْتقامُوا، ولا تأْخُذْ عنِ الَّذينَ مالُوا»(3).
* * *([34])
([1]) قال ابن حجـر في «التقريب» (ص 108): صـدوق، أخطأ في أحاديث من حفظه، من العاشرة، مات سنة (226ﻫ)، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
ينظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى»: (5/438)، «التاريخ الكبير»: (1/364)، «الجرح والتعديل»: (2/180)، «الثقات»: (8/99)، «الكامل»: (1/323)، «رجال صحيح البخاري»: (1/69)، «رجال مسلم»: (1/26)، «التعديل والتجريح»: (1/370)، «طبقـات الفقهـاء»: (ص149)، «ترتيـب المدارك»: (1/213 ـ 214)، «المعجم المشتمل» (ص81)، «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (1/117)، «تهذيب الكمال»: (3/124 ـ 129)، «تاريـخ الإسـلام»: (16/91 ـ 94)، «سـير أعـلام النبـلاء»: (10/391 ـ 395)، «تذكـرة الحفـاظ»: (1/409 ـ 410)، «ميـزان الاعتـدال»: (1/379 ـ 380)، «الديبـاج المذهـب»: (ص92)، «تهذيب التهذيـب»: (1/271 ـ 272)، «تقريب التهذيب»: (ص108)، «طبقات الحفاظ»: (ص 178)، «شجرة النور الزكية» (ص56).
([2]) قال القاضي عياض في «ترتيب المدارك»: (1/214) في ترجمة أخيه عبد الحميد بن أبي أويس: قال ابن شعبان: له ولأخيه عن مالك ما لا يحمل الموطأ وغيره.
وذكره القاضي عياض في رواة الموطأ في ترتيب المدارك (1/108).
([4]) قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء»: (10/392 ـ 393): ولولا أن الشيخان احتجا به لزحزح حديثه عن درجة الصحيح إلى درجة الحسن، هذا الذي عندي فيه.
وقال: الرجل قد وثب إلى ذاك البرِّ، واعتمده صاحبا «الصحيحين»، ولا ريب أنه صاحب أفراد ومناكير تنغمر في سعة ما روى، فإنه من أوعية العلم.
قال ابن حجر في «هدي الساري» (ص391): احتج به الشيخان إلا أنهما لم يكثرا من تخريج حديثه، ولا أخرج له البخاري مما تفرد به سوى حديثين، وأما مسلم فأخرج له أقل مما أخرج له البخاري، وروى له الباقون سوى النسائي فإنه أطلق القول بضعفه... وروينا في مناقب البخاري بسند صحيح: أن إسماعيل أخرج له أصوله، وأذن له أن ينتقي منها وأن يُعلِّمَ له على ما يحدث به ليحدث به ويعرض عما سواه، وهو مُشعرٌ بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه لأنه كتب من أصوله، وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره، إلا إن شاركه فيه غيره فيعتبر فيه.
([8]) ينظر «الجرح والتعديـل»: (2/181). ومعنى قوله: (ضعيف العقل، ليس بذاك) كما قال الذهبي في «تاريخ الإسلام»: (16/92): يعني أنّه لا يحسن الحديث، ولا يعرف يؤدّيه، أو يقرأ من غير كتابه.
([11]) هكذا وقع بالأصل، الورقة [35: ب]، والصواب: (الحسين) كما ذكرت المصادر التي ترجمت له. ينظر: «تاريخ بغداد»: (2/243)، «طبقات الحفاظ»: (ص379).
([12]) محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي، الآجري، أبو بكر، صاحب كتاب «الشريعـة» و«الأربعين». كان على مذهب الشافعي. قال الخطيب: كان ثقة صدوقا ديناً، توفي سنة (360ﻫ). ينظر ترجمته في: «الفهرست»، ابن النديم، دار المعرفة، بيروت، 1978م: (ص301)، «تاريخ بغداد»: (2/243)، «طبقات الحفاظ»: (ص379).
([13]) عنوانه: «الفوائد المنتخبة عن أبي شُعيب الحراني، وأبي يعقوب القطان عن شيوخهم». =
= نسبه للآجري فؤاد سزكين في «تاريخ التراث العربي»: (1/392).
وأشار إليه الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف على تحفة الأشراف»، تحقيق: عبد الصمد شـرف الديـن، زهـير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيـروت، لبنان، ط2/ 1983م: (2/422) قال: وفي «فوائد الآجرِّيّ». وفي «المجمع المؤسس»: (2/260) قال: (وجزءاً من حديث أبي بكر الآجري عن أبي شعيب الحراني، ويوسف القاضي وغيرهما).
وهذا الكتاب طبع في رسالة ماجستير، تحقيق الطالبة منيرة بنت سليمان الفرهود، بجامعة الملك سعود بالرياض، عام 2008 م.
([14]) قاله البخاري في «التاريخ الكبير»: (1/364)، وابن حبان في «الثقات»: (8/99)، وابن منجويه في «رجال مسلم»: (1/28)، وابن عساكر في «المعجم المشتمل» (ص81)، والذهبي في «سير أعلام النبلاء»: (10/395) وغيرهم.
([15]) نقله الكلاباذي في «رجال صحيح البخاري» (1/69): عن أبي داود، وقاله أبو إسحاق الشيرازي في «طبقـات الفقهـاء»: (ص149). وينظـر: «المعجم المشتمل» (ص81)، «تهذيب الكمال»: (3/129)، «تاريخ الإسـلام»: (16/93)، «سـير أعـلام النبلاء»: (10/395).
([16]) إحفاء الشوارب: إزالة ما طال على الشفتين حتى تبين الشفة بياناً ظاهراً. «شرح الزرقاني على الموطأ»: (4/425):
([17]) جمع لِحِية بالكسر فقط، اسم لما ينبت على الخدين والذقن، ومعناه: توفرها لتكثر. «شرح الزرقاني على الموطأ» (4/426).
([18]) أخرج متابعة عبد الله بن مسلمة القعنبي: أبو داود في «سننه»: كِتَاب التَّرَجُّلِ، باب في أخذ الشارب (4/84) برقم (4199).
([19]) «الموطأ» برواية يحيى بن يحيى الليثـي»: كتاب الجامع، باب: السنة في الشَّعْرِ (2/947) برقم (1696).
([20]) وتابعه جماعة أيضاً منهم: معن بن عيسى عند الترمذي في «سننه»: كتاب الأدب، باب: ما جاء في إِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ (5/95) برقم (2764) قال الترمذي: حسن صحيح. وخرجهمن طريـق معن أيضاً: ابـن عبـد البر في «التمهيد»: (24/143). ومنهم: أبو مصعب الزهري بروايته «للموطأ»: كتاب الجامع، باب: السنة في الشعر (2/125) برقم (1990). ومنهم: عبد الرحمن بن القاسم في روايته «للموطأ» (ص370) برقم (524).
ومنهم: روح بن عبادة عند ابن عبد البر في «التمهيد»: (24/143).
ومنهم: قتيبة بن سعيد عند مسلم في «صحيحه»: كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة (1/222) برقم (259).
ومنهم: عبد الله بن نافع عند ابن عبد البر في «التمهيد»: (24/143).
ومنهم: عبد الله بن وهب، ومطرف بن عبد الله، وعبد الله بن يوسف عند أبي عوانة في «مسنده»: مبتـدأ كتاب الطهارة، باب: بيان الطهارات التي تجب على الإنسان في بدنه (1/161 ـ 162) برقم (467).
([21]) قال ابن عـبد الـبر في «التمهيد»: (24/141): وتوفي أبو بكر سنة ثلاث وسبعين ومئة ولا يوقف على اسمه.
قال المزي في «تهذيب الكمال»: (33/145 ـ 147): أبو بكر بن نافع القرشي، العدوي، المدني، مولى عَبد الله بن عُمَر. رَوَى عَن: سالم بن عَبد الله بن عُمَر، وأبيه نافع مولى ابن=
= عُمَر، رَوَى عَنه: جرير بن خازم، وسليم بن مسلم المكي... ومالك بن أنس، روى له مسلم، وأبو داود، والتِّرْمِذِيّ، والنَّسَائي في (حديث مالك).
([22]) وقالـه ابن أبي حاتـم الرازي في «الجرح والتعديل»: (6/138)، وابن عبد البر في «التمهيد»: (24/141).
([23]) نقله عن ابن معين: الدوري في «تاريخ ابن معين»، رواية الدوري، تحقيق أحمد محمد نور سيف، مركـز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، ط1/ 1979م: (3/231) برقم (1083)، وابن أبي حاتم الرازي في «الجرح والتعديل»: (6/138)، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء»: (7/298).
قال ابن عدي في «الكامل»: (7/298): روى عنه مالك، ولولا أنه لا بأس به لما روى عنه مالك؛ لأن مالكاً لا يروى إلا عن ثقة، وقد روى غير مالك عن أبي بكر بن نافع أشياءً غير محفوظة، وأرجو أنه صدوق لابأس به.
([24]) قاله الإمام أحمد في «العلل ومعرفة الرجال»، أحمد بن حنبل، تحقيق وصي الله بن محمد عباس، المكتب الإسلامي، بيروت / دار الخاني، الرياض، ط1/1988م: (3/99) برقم (4374)، ونقله عن الإمام أحمـد: ابن أبي حاتم الرازي في «الجرح والتعديل»: (9/343)، والذهبي في «ميزان الاعتدال»: (7/343).
ووثقـه الترمـذي في «سننه»: (5/95)، وابن أبي حاتم الرازي في «الجرح والتعديل»: (6/138)، وذكـره ابـن حبان في «الثقـات»: (7/655)، ووثقـه ابـن عبـد الـبر في «التمهيد»: (24/141).
([25]) قال ابن سعد في «الطبقات الكبرى»: (القسم المتمم) (ص 409): عبد الله بن نافع مولى عبد الله بن عمـر بن الخطاب، ويكنى أبا بكر، مات سنة أربع وخمسين ومئة بالمدينة في خلافة أبي جعفر، له أحاديث، وهو ضعيف.
وضعفه الترمذي في «سننه»: (5/95)، والذهبي في «ميزان الاعتدال»: (7/343).
([26]) قال ابن سعد في «الطبقات الكبرى»: (القسم المتمم) (ص 408): عمر بن نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب، كان ثبتاً، روى عنه مالك بن أنس، وكان قليل الحديث، ولا يحتجون به، وتوفي بالمدينة في خلافة أبي جعفر.
قال الترمذي في «سننه»: (5/95): وعمرُ بن نافعٍ ثقةٌ.
قال الذهبي في «ميزان الاعتدال»: (7/343): وأما عمر فالظاهر أنه أوثق الإخوة؛ لأنه مخرج في الصحيحين، وما علمت فيه مقالاً.
([27]) ذكر ابن حجـر في «المعجم المفهرس» (9/157) أنه سمعه وساق سنده إلى الدارقطني رحمه الله.
وأحال ابن حجر أيضاً إلى كتاب الدارقطني في كتابه «التلخيص الحبير»: (3/157).
وذكره في مؤلفات الدارقطني أيضاً: السخاوي في «فتح المغيث»: (1/343)، والسيوطي في «تدريب الراوي»: (1/336).
وهذا الكتاب لم أقف عليه، فقـد راجعت «فهارس مخطوطات آل البيت» فيما يخص مؤلفات الحديث النبوي (1/60 ـ 62) ولم يُذكر هذا الكتاب.
وقد وقفت على كتاب له العنوان ذاته «تذكرة المؤتسي في أخبار من حدث ونسي» للإمـام =
= السيوطي، تحقيق صبحي البدري السامرائي، طبعة دار السلفية بالكويت، ط1/ 1404ﻫ ـ 1984 م.
وقد راجعت هذا الكتاب من أوله لآخره ولم أقف على هذا الأثر.
([28]) والمراد: أن ابـن السبيل إذا مرَّ ببئر عليها قوم مقيمون فهو أحق بالماء منهم، لأنه عابر وهم مقيمـون. ينظـر: «غريب الحديث» لابن الجوزي: (1/113)، «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير: (1/198)، «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري، (1/156)، «لسان العرب»: (1/40).
([29]) هذا الأثر أخرجه حميد بن زنجويه في كتابه «الأموال» بلا طبعة: (2/425) من طريق ابن أبي أويس، عن كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمثله مع بعض الزيادة.
وتابع مالك عـن كثير بن عبد الله: ابن واقد المدني عند يحيى بن آدم في كتاب «الخراج»: (ص124) برقم (320)، ومن طريق يحيى بن آدم خرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: كتاب الضحايا، باب: صاحب المال لا يمنع المضطر فضلاً إن كان عنده (10/4) برقم (19454).
قلت: مدار هذه الأسانيد كلها على كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف.
قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: (ص460): كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف=
= المزني، المدني، ضعيف أفرط من نسبه إلى الكذب.
والذي أراه: أن هـذا الأثر يعتضد بكثرة شواهده ومتابعاته ويرتقي إلى درجة الحسن، فلقد تابع كثير بن عبد الله عبد الرحمن بن أبي ليلى.
وأخرج هذه المتابعة أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه «الأموال»، تحقيق: خليل محمد هراس، دار الفكر، بيروت/ 1988م: (ص274 ـ 275) برقم (738)، وابن زنجويه في كتاب «الخراج»: (2/424)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: كتاب الضحايا، باب: صاحب المال لا يمنع المضطر فضلاً إن كان عنده (10/3) برقم (19453) كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه به.
([31]) قال ابن منظور في «لسان العـرب»: مادة: تنأ (1/40): وقالوا: تنا في المكان فأبدلوا فظنه قوم لغة، وهو خطأ. قال الأزهري: تنخ بالمكان وتنأ، فهو تانخ وتانئ، أي: مقيم.
([32]) خرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» باب: من قال هو دين فانظروا عمن تأخذونه (1/416) برقم (444) قال: حدثنا الحسنُ بن سهل بن سعيد العسكري... وساق بقية السند به.
وروى الخطيب في «الكفاية» (ص 49) بسنده عن ابن عمر مرفوعاً نحوه.
قلت: وفيه الحسن بن سهل بن سعيد بن مهران الأهوازي، من أهل عسْكَرِ مُكْرَم.
قال ابن حجر في «لسان الميزان»: (2/212): روى عن أحمد بن منصور بإسناد صحيح خبراً مُنكراً.
([34]) أخرجه ابن عدي في «الكامل»: (1/149) بسنده إلى المبارك مولى إبراهيم قال: حدثنا عطاف بن خالد... ثم ساق بقية السند به.
ومن طريـق ابـن عدي أخرجـه الخطيب في «الكفاية» (ص121)، وابـن الجوزي في=
= «العلل المتناهية في الأحاديث الواهيـة»: تحقيـق: خليـل الميس، دار الكتب العلميـة، بيروت، 1403ﻫ: باب: النظر فيمن يؤخذ منه العلم (1/130) برقم (186).
قال ابن الجوزي: هذه الأحاديث ليس فيها شيءٌ يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما حديث ابن عمر فإن عطاف بن خالد مجروح، وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما لا يشبه حديثهم فلا يحتج به.